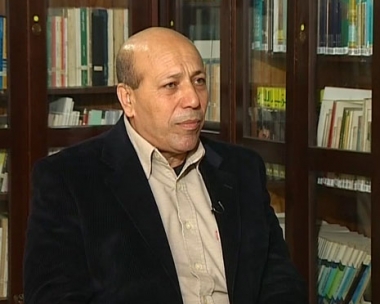اضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للإقرار، بعد يومين من اختفاء ثلاثة شبان إسرائيليين قرب الخليل، بأن حركة حماس تقف خلف اختطافهم.
وتراجع نتنياهو بذلك عن الاتهام العمومي للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس بالمسؤولية عن عملية الاختطاف، وعن إعادتهم إلى أهلهم سالمين. لكن أصابع الاتهام الإسرائيلية، سواء للسلطة الفلسطينية أم لحماس، لم تقنع الكثير من الإسرائيليين، الذين يعتقدون أن المسؤول الحقيقي عن الاختطاف هو جمود عملية التسوية من ناحية والقوات الإسرائيلية التي جرت العملية تحت نظرها من ناحية ثانية.
ويهرع كثيرون للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة سبب إخفاق الشرطة الإسرائيلية في إطلاع أجهزة الأمن الأخرى على عملية الاختطاف، رغم قيام أحد المختطفين بالإبلاغ شخصياً عن ذلك للشرطة.
وأعلن نتنياهو، في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن "إسرائيل" تعتقد أن حماس أو إحدى الخلايا الإسلامية المرتبطة بها هي المسؤولة عن اختطاف المستوطنين الثلاثة قرب غوش عتسيون.
وجاء هذا الإعلان بعد أن شرعت قوات الاحتلال بتنفيذ أوسع حملة اعتقال ضد عناصر حماس والجهاد الإسلامي بحثاً عن أية معلومات قد تقود إلى وضع اليد على المستوطنين. وفي هذا الإطار تم اعتقال أكثر من مئة من كبار نشطاء هذين التنظيمين المعروفين بنشاطهما السياسي أو النقابي.
ولاحظت مصادر إسرائيلية أن الغاية من الاعتقال، خصوصاً الضغط على حماس وقيادتها، حققت بعض جوانبها عبر تنصّل غالبية المتحدثين باسم حماس من المسؤولية عن العملية، بل أن بعض المسؤولين في الحركة أصبحوا يتحدثون عن أن الاختطاف مجرد رواية إسرائيلية لم تتأكد بعد، ويمكن أنها تستهدف حكومة الوفاق الفلسطينية. كما أن بعض المتحدثين بلسان حماس طالبوا "إسرائيل" بالكشف عن براهينها، إن كانت تملك دلائل على تورط الحركة في العملية. ولكن الهدف الأساس من الاعتقالات الواسعة، خصوصاً الحصول على معلومات من المستويات الميدانية، لا يبدو أنه تحقق. فالمؤتمر الصحافي الذي عقده نتنياهو ووزير "دفاعه" موشي يعلون و"رئيس الأركان" بني غانتس لم يعط أي انطباع بوجود طرف خيط.
ومن الجائز أن عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة أربكت دفعة واحدة كل الأطراف. فالحكومة اليمينية الإسرائيلية التي طالما انتهجت سياسة «القامة المنتصبة»، ومررت قبل أيام مشروعاً يكبل يد أي حكومة في أي عملية تبادل أسرى، تجد نفسها مضطرة لانتهاج سياسة تصعيدية، ليس هذا هو الوقت المناسب إقليمياً ودولياً لها. كما أن هذه العملية أظهرت أن حالة الاستعداد القصوى والتحذيرات الدائمة لمواجهة عمليات الاختطاف لم تجد نفعاً.
ولإخفاء الحرج الذي أصاب جهاز «الشاباك» يشيع المقربون منه في وسائل الإعلام أن هذا الجهاز بات يعرف كيف يعيد رسم صورة الأحداث قبل الاختطاف، من مكان وقوعه إلى مكان حرق السيارة المستخدمة. ويوضح مراسلون أن جهداً هائلاً تجتمع فيه المعلومات الميدانية والاستخبارية من العملاء ومن أجهزة الرصد والتنصت الالكتروني ومن كاميرات المراقبة لرسم الصورة كاملة، لكن عملية إخفاء الحرج الكبرى هي الجارية سياسياً، عبر حملة إشراك الجمهور الإسرائيلي بأسره في عملية البحث والصلاة من أجل المستوطنين المفقودين، على أمل أن يبعد ذلك خطر الاتهام المباشر للحكومة بالمسؤولية عن الاختطاف.
ورغم إعلان القادة الإسرائيليين أنهم ينطلقون في بحثهم المكثف عن المستوطنين الثلاثة من قاعدة أنهم أحياء، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن المعلومات المتوفرة حتى الآن، إضافة إلى دروس الماضي في الضفة الغربية، لا تبقي مجالاً كبيراً للتفاؤل بشأن مصيرهم، فتاريخ عمليات الاختطاف في الضفة الغربية يشهد على أنها أمام واحد من خيارين: إحباطها قبل أن تقع أو العثور على المختطفين ضحايا بعد ذلك.
ورغم أن الجيش الإسرائيلي تعامل مع الاختطاف على أنه جرى في منطقة محددة، وزج بآلاف الجنود في تلك المنطقة لمنع احتمال نقل المختطفين إلى غزة أو سيناء أو الأردن، فإنه حاول من خلال علاقات مع كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية تأكيد منع هذا الاحتمال. ومعروف أن السلطة الفلسطينية وثقت تنسيقها الأمني مع "إسرائيل" لتجاوز هذه الأزمة من ناحية، ولمنع "إسرائيل" من استغلالها ضد «حكومة الوحدة» من ناحية ثانية. وربما أن هذا كان السبب وراء عودة "إسرائيل" رسمياً إلى اتهام حماس بالوقوف خلف العملية.
وفي كل حال فإن اختطاف المستوطنين وضع السلطة الفلسطينية أمام مأزق خطير. فمن ناحية كان وقع الاختطاف فائق الإيجابية في الشارع الفلسطيني، خصوصاً أنه تم على خلفية إضراب الأسرى الإداريين. ومعروف أن مسألة المعتقلين تشكل مركز توحيد فلسطيني بارزاً، حيث يندر أن تخلو عائلة من وجود أسير من أبنائها، فضلاً عن التضامن الوطني العام معهم. ومن ناحية أخرى فإن التعاطف مع عملية اختطاف المستوطنين جاء تنفيسا عن حقد يكنه الفلسطينيون للمستوطنين، خصوصاً من طلاب المدارس الدينية ممن يعربدون في القرى والبلدات باسم جماعة «شارة ثمن» لتخريب الممتلكات والمزروعات.
وقد ردت السلطة الفلسطينية على اتهامات إسرائيل لها بأن العملية جرت في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية التامة، وأن الاتهام يجب أن يوجه للجيش وللحكومة الإسرائيليين. لكن نتنياهو، في مؤتمر صحافي، شدد على أن الذنب في عمليات من هذا النوع يقع على عاتق الجهة المسؤولة عن المنطقة التي انطلق منها منفذو عملية الاختطاف. ولهذا فإن عمليات التفتيش حتى في المنطقة «أ» تتم من بيت إلى بيت، وعلى نطاق واسع، خصوصاً في منطقة دورا في جوار الخليل.
في كل حال، بدأت مرحلة توجيه الاتهامات بالاتساع في "إسرائيل". فـ«الشاباك» الذي كثيراً ما ادعى قدرته على توقع الأحداث والتحذير منها وإحباطها قبل وقوعها وإفشالها إذا ما بدأت، يجد نفسه اليوم في موضع الاتهام. ويطرح كثيرون أسئلة ثاقبة عن إخفاق الشرطة و«الشاباك» والجيش فضلاً عن إخفاق الحكومة الإسرائيلية نفسها، وهذا ما دفع معلقاً سياسياً كبيراً، مثل شمعون شيفر في «يديعوت احرونوت»، للتساؤل عن مدى حماقة من يعتقد أن أناساً تحت الاحتلال يمكنهم أن يسكنوا ويهدأوا ويقبلوا بإملاءات الاحتلال.
وفي كل حال ولمنع تصاعد الخلاف الداخلي في "إسرائيل" جراء هذه العملية والاتهامات المتبادلة، طلب نتنياهو من وزرائه الكف عن إطلاق التصريحات بهذا الشأن. وقد فرضت السلطات الإسرائيلية حصاراً على منطقة الخليل وقيوداً على باقي مناطق الضفة الغربية، كما أن طائراتها هاجمت عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة، ما ادى إلى جرح امرأة.
عموماً غدا أساس الجهد الإسرائيلي للعثور على المختطفين استخبارياً، بسبب الاعتقاد بأن عملية الاختطاف خُطط لها جيداً وبمهنية كبيرة. وحسب مصادر التقدير، فان مخططي الاختطاف كانوا يعرفون جيداً تحقيقات الجيش والمخابرات الإسرائيلية، وتمكنوا من تفادي الأخطاء التي تؤدي إلى القبض عليهم بسرعة. والتقدير هو أن هذه منظمة صغيرة وسرية لا تحدث ضجيجاً ولا تدير مفاوضات.
عموماً يشعر إسرائيليون كثر بالخجل بسبب العملية. وقال ضابط رفيع المستوى «القول إن العنوان كان مكتوباً على الحائط هو أمر مهين. فقد صرخنا في كل مكان أن احذروا».