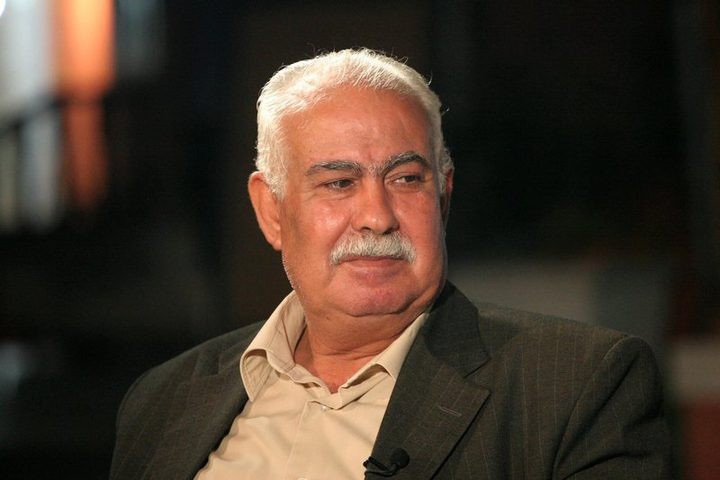منذ عقود، لم تشهد الولايات المتحدة الأميركية، اضطرابات أمنية واستنفاراً، كالذي تشهده خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعلى نحوٍ خاص، لم تشهد العاصمة واشنطن مثل هذه الإجراءات، خلال زيارة أي رئيس حكومة إسرائيلية.
الولايات المتحدة تشهد حالة من الاستقطاب والانقسام والتحريض على العنف، كانت تجلّت بصورةٍ فاضحة حين فاز جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية عام 2020، واقتحام «الكابيتول» من قبل أنصار المرشّح للرئاسة دونالد ترامب، ثم في محاولة الاغتيال للأخير، بينما كان يلقي خطاباً أمام أنصاره في الأسابيع الأخيرة. ومنذ 9 أشهر، تشهد الولايات المتحدة اهتماماً متزايداً للمرة الأولى بمجريات الصراع الجاري على الأرض الفلسطينية وفي منطقة الشرق الأوسط، حيث تتشكّل جماعات ضغط، مناصرة للقضية الفلسطينية، وتتصاعد التظاهرات الاحتجاجية، المطالبة بوقف الحرب العدوانية، ووقف تمويل الدولة العبرية بالسلاح.
كانت الجامعات الأميركية الكبرى، أهمّ الساحات التي شهدت اضطرابات واحتجاجات واسعة، للضغط على إداراتها، من أجل وقف تعاملها واستثماراتها مع الجامعات والمؤسسات الإسرائيلية، من حيث كونها تنطوي على مؤشّرات حاضرة ومستقبلية تتعلق بالسياسة الأميركية، وبقضية الصراع الفلسطيني والعربي الصهيوني.
على مستوى قمة السياسة الأميركية، يتنافس الحزبان الديمقراطي والجمهوري على إجراء لقاءات مع نتنياهو، ويسعى كلا المرشحين لكسب رضا اللوبي اليهودي عَبر استرضاء نتنياهو.
رئيس مجلس النواب الجمهوري، الذي وجّه الدعوة لنتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس، حذّر من وقوع اضطرابات خلال استقباله، وهدد باستخدام القوة، واعتقال المسؤولين عن أيّ اضطراب.
سياج أمني حول مقرّ إقامة نتنياهو، وتفتيش الزوّار الذين قرروا الدخول إلى القاعة، وقد جرى فعلاً اعتقال أكثر من 300 ناشط بعضهم من اليهود المناصرين للقضية الفلسطينية.
ائتلاف «يهود من أجل وقف تسليح دولة الاحتلال»، نظّم احتجاجاً صاخباً من داخل الكونغرس، والأرجح أن يواجه الخطاب، عزوف عدد من النواب الديمقراطيين عن الحضور، واعتراض بعضهم الآخر على الخطاب.
قبل 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، كان حضور القضية الفلسطينية في المجتمع الأميركي يقتصر على الاهتمام الكاذب، للإدارات الأميركية، التي كانت تصدر الكثير من الوعود الكاذبة، لتخدير الفلسطينيين الذي راهنوا على دورها في تنفيذ «حل الدولتين».
لم تكن الإدارات الأميركية الديمقراطية والجمهورية التي احتكرت الملف، قد غادرت منطق إدارة الأزمة، وإظهار الانحياز الكامل لإسرائيل، وضمان أمنها وتفوّقها على كل ما حولها، وتصفية القضية الفلسطينية، حيث كانت «صفقة القرن» أبرز معالم تلك السياسات. برأينا لم يتغير جوهر الموقف الرسمي الأميركي، خلال فترة بايدن الذي أعلن من بيت لحم، أنّه صهيوني، وكرّر الإعلان عن انتمائه في الفترة الأخيرة، واختار أن يكون وبلاده شريكاً كاملاً لدولة الاحتلال في حربها الإبادية على الشعب الفلسطيني.
عملياً لا فرق بين الإدارتين الجمهورية والديمقراطية، إزاء ما يجري في ميدان الصراع، وبشأن آفاقه، الأمر الذي يضع مناصري الشعب الفلسطيني أمام التردّد بين خيارات المقاطعة، أو المشاركة عَبر أوراق بيضاء، أو اختيار الأقل سوءاً، من بين المرشحين كامالا هاريس، وترامب.
قبل 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، كان المجتمع الأميركي يبدي اهتماماً ويتخذ موقفاً في الانتخابات، استناداً إلى قضاياه الداخلية التي تتصل بموضوع الصحة، أو الضمان الاجتماعي، أو الهجرة، أو الموقف من الإجهاض.. حتى أنّ موضوع الموقف من «المثليين»، كان قد حظي باهتمام أوسع من قبل المواطن الأميركي، قياساً بالموقف من القضية الفلسطينية.
ثمة من قال إنّ المواطن الأميركي يهتمّ بكلبه أكثر من اهتمامه بحروب قد تشهدها أوروبا طالما أنّ البلاد تنعم بالاستقرار والرفاه.
7 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، هزّ الشجرة الأميركية من جذورها حتى قال أحد النشطاء الأميركيين إن الفلسطينيين يحرّرون الولايات المتحدة.
مسألة تحرير أميركا، تعني تحرّرها من الوهم الذي يصدر عن الطبقة السياسية التي يحكمها الحزبان «الديمقراطي» و»الجمهوري»، من أكاذيب الخطاب الإنساني الديمقراطي، ومن منظومة القيم الكاذبة التي تناقضها سياسات دائمة نحو شن الحروب، ومناصرة العدوانية على المستوى الدولي، ونهب ثروات الشعوب، ودعم الديكتاتوريات، في دول العالم.
ثلاثة أطراف هي الفاعلة في رسم السياسات والإستراتيجيات الأميركية، أوّلها، المجتمع الأميركي، وطبيعة الاهتمامات الاجتماعية، التي تواجه المواطن، ويتجلّى تأثير ذلك خلال الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، والانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى انتخاب حكّام الولايات، وهذه كلها محكومة لتنافس الحزبين الكبيرين «الجمهوري» و»الديمقراطي».
الطرف الثاني، يتعلق بالبناء الفوقي، حيث الإدارة التي يقف على رأسها الرئيس، بالإضافة إلى سلك العدالة والقضاء، والحكّام، ومجلسي النواب والشيوخ، وهذه الطبقة، محكومة مرة أخرى، بمخرجات التنافس بين الحزبين الكبيرين اللذين يضعان عقبات كبيرة أمام تقدم أي كتلةٍ حزبية أخرى إلى حلبة المنافسة. الطرف الثالث، هو اللوبي اليهودي الأميركي، الذي يملك إمكانيات مادية وإعلامية هائلة، ويلعب دوراً أساسياً في رسم السياسات لدى الإدارة التنفيذية والتشريعية.
اللوبي اليهودي يلعب دوراً أساسياً في الانتخابات، بمختلف أشكالها، من خلال تقديم الدعم المالي ورشوة النوّاب، والنافذين في السياسة الأميركية، والمؤسسات الاجتماعية والسياسية والإعلامية والاقتصادية.
منذ هجوم «طوفان الأقصى» في 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، الذي شكّل اختراقاً إستراتيجياً غير مسبوق ووضع دولة الاحتلال أمام زلزال كبير، قد شكّل، أيضاً، اختراقاً إستراتيجياً غير مسبوق للسياسة الأميركية.
قد لا يكون الوضع مختلفاً على مستوى الطبقة السياسية والتشريعية الأميركية حتى الآن، ولكنه أنشأ وضعاً مختلفاً على مستوى المجتمع الأميركي، الذي يشهد حراكات واسعة وعميقة تحفر في عمق وعي المواطن والمجتمع الأميركي، لصالح الرواية والقضية الفلسطينية.
العالم كلّه يهتزّ، بعد «طوفان الأقصى»، والولايات المتحدة ليست خارج هذا الوضع، والأرجح أن تداعيات الصراع الجاري ستعكس نفسها على تراكيب وسياسات الإدارات التنفيذية والتشريعية خلال السنوات المقبلة، لصالح القضية الفلسطينية.