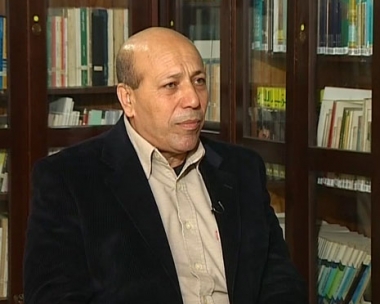بين إبداع المقاومة في الجنوب وفي غزة: كسر الحصار بالحصار في الحرب الإسرائيلية
بين الجنوب الفلسطيني والجنوب اللبناني أكثر من رابط وتاريخ وعدو وحرب وتموز وآب. بين قطاع غزة والجنوب اللبناني مقاومة تشهد على الروابط والتاريخ والعدو، وتشهد على الزمان والمكان.
وبين الجنوبين صلة لم تنقطع على الأقل منذ انطلقت المقاومة الفلسطينية بعد حرب العام 1967، حين كان المقاومون يصلون بالزوارق من الجنوب اللبناني إلى الجنوب الفلسطيني. وعندما سيطر العدو الإسرائيلي على البحر لم يعدم المقاوم وسيلة للتواصل بين الجنوب اللبناني والجنوب الفلسطيني حتى لو دارت الأرض ومرّ بالسودان وسيناء عبر نفق.
وحكاية الجنوبين قديمة، لكن أمجد فصولها مقاومة. فمن الجنوب اللبناني في زمن غير زمان الظلمة خرج السوري خالد أكر والتونسي ميلود نجاح ليصنعا لحظة مجد في ليلة الطائرات الشراعية في 25 تشرين الثاني العام 1987. وكما لو أن هذه العملية كانت رصاصة البدء، انطلقت الانتفاضة الفلسطينية الأولى بعد أقل من أسبوعين ومن غزة تحديداً. وأكدت هذه الأحداث أن الجنوبين اللبناني والفلسطيني وتَران متناغمان على آلة موسيقية عربية واحدة.
اليوم وبفارق ثماني سنوات، خاض الجنوبان حربيهما ضد عدوهما الواحد في ظروف تتشابه حد التوأمة وتتمايز حد الإبداع. فبالأدوات الكفاحية نفسها تقريباً شق كل جنوب طريقه حاملاً على ظهره عبء وإرث أمّة من دون أن يملك سلاحها.
في لبنان العام 2006 وجدت مقاومة «حزب الله» نفسها شبه وحيدة في المعركة، بعدما اعتبر العرب والغرب التجرؤ على "إسرائيل" «مغامرة». ولولا الخجل، لهلّل بعض العرب للقوات الإسرائيلية التي «ستسحق رأس المقاومة وتنهي هذا الغرور».
وفي العام 2014، وبالرغم من أن الأحداث تطورت في غزة في نطاق التضامن مع هبّة الشعب الفلسطيني في الضفة، إلا أن العبارات ذاتها تكررت على لسان بعض العرب: حماس تخوض مغامرة وعليها أن تدفع الثمن. وربما أن الوضع العربي في ظل حرب غزة كان أسوأ حيث لم يكتف بعض العرب بعدم إدانة العدوان الإسرائيلي بل شدّوا على يديه داعين الله «أن يكثر من أمثال نتنياهو». وباتت ألسنة بعض العرب أقوى سلاح إعلامي في يد الدعاية الصهيونية.
ولكن ما يميز المقاومة في لبنان وفلسطين أنها تحفر الصخر ولا تسمع كلام المشككين. إنها تصمّ آذانها لأن تركيزها يتجه إلى مكان آخر. "إسرائيل" عدو كاف. ومن يرى في "إسرائيل" عدواً ليس في حاجة لأن يبحث عن أعداء آخرين. وهنا كان إعجاز المقاومة في حرب تموز العام 2006 وإعجازها في حرب تموز العام 2014.
كان العدو وهو يحارب في الجنوب اللبناني عينه على الفلسطينيين في أحشاء الوحش، يريد إثبات عدم جدوى استخدام القوة معه. وفي نظر نفسه كانت قدرته على تحقيق النصر أمراً ثابتاً وقاطعاً ونهائياً ولا حاجة لتكراره.
إنها سياسة التيئيس من احتمال تغيير الوضع القائم من دون رضى "إسرائيل". وسمّها إن شئت ردعاً يطول لسنوات وسنوات في ظل الحرب المفتوحة من أجل البقاء. والعرب، في نظر "إسرائيل"، إن سالموا أو حاربوا يبقون عرباً، وهم لا يتغيرون حتى لو صاروا بيادق على رقعة الشطرنج.
والمقاومة لا هدف لها سوى إخراج العدو عن قناعاته هذه وعن توازنه وصولاً إلى إفقاده ثقته بنفسه. وليس مجازفة القول إن المقاومة في جوهرها، سواء في الجنوب اللبناني أو الجنوب الفلسطيني، مجرد نموذج. إنها تريد القول لأمة بأكملها أنه إذا توفرت إرادة فإن إمكانية هزيمة العدو واردة. فسطوة العدو ليست قدراً، وهو قوي لأننا ضعفاء، وهو قادر لأننا عجزة.
وعندما وفّرت المقاومة في الجنوب اللبناني نموذج انتصار ازدهت أمة بكاملها بالنصر، وتمنت لو أن للأمة العربية بأسرها، وليس للبنان أو جنوبه فقط، مثل «حزب الله». فـ«حزب الله» هو في أفضل الأحوال نصف الشيعة في لبنان الذين لا يزيدون عن ثلث اللبنانيين الذين لا يزيدون كثيراً عن واحد في المئة من العرب جميعاً. ولكم أن تتخيلوا الإسرائيلي وهو يتحمل هذا النموذج وقد تمدد على عشرة في المئة مثلاً من العرب.
وعندما أفلحت المقاومة في غزة، وعلى رأسها «كتائب القسام»، ليس فقط في الصمود، وإنما في اقتحام المواقع الإسرائيلية ومحاصرة الحصار بالحصار، بدا الأمر إعجازاً. فقرار قصف تل أبيب لم يعد إستراتيجياً، صار تكتيكاً بعدما امتلكت غزة الفقيرة والمحاصرة القدرة على إنتاج الصواريخ.
وعندما سيطرت "إسرائيل" على الأجواء والبحار والحدود وجدت المقاومة في غزة في الأنفاق سبيلاً لكسر هذه السيطرة. وصار قطاع غزة الذي يشكل أقل من واحد ونصف في المئة من أرض فلسطين قادراً على الوصول بصواريخه إلى كل فلسطين. وكان هذا هو النموذج القاتل لـ"إسرائيل": الفقير المحاصر المنبوذ حتى من أهله، لكن المؤمن بقضيته، يتسلح ويتدرب ويشل مزايا العدو وقواته الخاصة.
فالعدو كان يهدد بالحرب البرية، وعندما بدأت وخبر أثمانها كان المبادر للخروج منها من طرف واحد. حدث هذا في الجنوب اللبناني وحدث هذا مكرراً في الجنوب الفلسطيني.
في لبنان كان مجد بنت جبيل وجوارها، وفي غزة كان مجد الشجاعية وخزاعة. في لبنان ابتكر العقل الإسرائيلي المسكون بالانتقام «نظرية الضاحية»، وكان يرمي إلى تكبيد مجتمع المقاومة في لبنان أعلى تكلفة. 100 قذيفة في مقابل كل صاروخ، وبرج سكني في الضاحية في مقابل كل بيت يتضرر في "إسرائيل".
في غزة تفيد الأرقام الرسمية الإسرائيلية بإطلاق أكثر من خمسة آلاف طن متفجرات خلال الأيام الثلاثين الأولى من الحرب. لمن يريد القياس: تقريباً عشرة أطنان و400 كيلوغرام لكل كيلومتر مربع واحد.
في غزة جرى تنفيذ «نظرية الضاحية» تقريباً في كل مكان من رفح إلى بيت حانون، من جنوب القطاع إلى شماله. كل مدينة في غزة كانت ضاحية وكل بلدة وقرية ومخيم.
ولكن نظرية الضاحية كانت تقصد «كيّ الوعي»، وأن تزرع في الذهن دماراً لا يغفل عن مشاهد العقل لسنوات أو لعقود. في "إسرائيل" بعدما قرأوا على الأرض أن الردع لا يدوم وقد لا يكون موجوداً، صار هناك من يشكك في أن الهدوء على طول الحدود مع لبنان ناجم عن ردع.
وفي غزة ثبت للإسرائيلي بشكل قاطع أن الردع غير موجود في قاموس أهل ذلك البلد. لم يبق أمام العدو في لبنان إلا الدمار من دون خطة خروج، وليس لديه في غزة سوى الدمار من دون خطة خروج.
وحتى بعدما فهم الإسرائيلي عقم منطق أن «ما لا يتحقق بالقوة يمكن أن يتحقق بمزيد من القوة» فإنه ما زال يناطح الواقع ويرفض تغيير الوجهة.
في لبنان اضطرت "إسرائيل" لتشكيل لجنة «فينوغراد» لبحث إخفاقات الحرب. في غزة يضطر كل إسرائيلي تقريباً لأن يعتبر نفسه لجنة تحقيق تبحث في إخفاقات الحرب: كيف أن الحصار لم يضعف غزة وكيف عزز قوتها؟ كيف لم تعرف الاستخبارات الإسرائيلية بما يجري وكيف لم تفلح في ردع حماس والفصائل؟
أسئلة غزة الكثيرة تعيد إلى الواجهة أسئلة أكثر بخصوص الجنوب اللبناني و«حزب الله». لكن أهم هذه الأسئلة: ماذا تخبئ لنا المواجهة المقبلة إذا وقعت؟ هل هناك في "إسرائيل" من يثق بنفسه وقادر على تقديم جواب؟