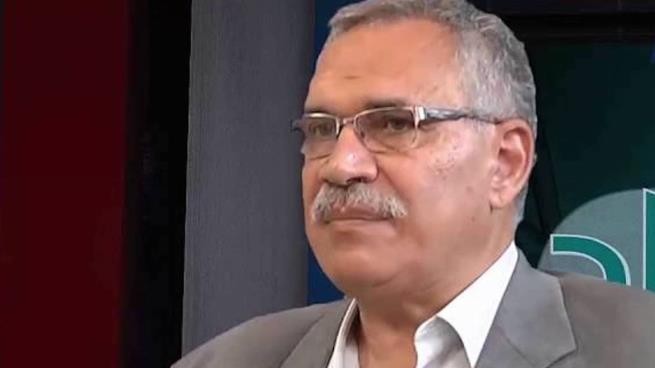معين الطاهر
تتسع الخيارات المتاحة دومًا، إذا توافرت الإرادة والعزم على تغيير موازين القوى والانقلاب عليها، بعد أدراك مواطن القوة والضعف، وتضيق كلما ساد الاعتقاد أن الوضع الراهن قدرٌ دائمٌ لا يتغيّر، وينبغي القبول به. ولا تنفصل خيارات الشعوب عن تاريخها ورؤيتها لمستقبلها وحقها في الحرية والعدالة، وأي انحراف عن ذلك لا يعدو كونه استسلامًا لإرادة المستعمر، ورضوخًا لإملاءاته، وحفاظًا على مصالح قيادات ارتبطت به وتحالفت معه. من هنا، تأتي أهمية رؤية الخيارات في ضوء قدرتها على تغيير الواقع والتأثير فيه أو الاستسلام له.
شهد عام 1974 تحولًا في خيارات الحركة الوطنية الفلسطينية، عندما تمت الموافقة على برنامج النقاط العشر الذي دعا إلى إقامة سلطة وطنية فلسطينية، وُصفت يومها (تبريرًا لهذا التحوّل) بالمقاتلة، على أي بقعة أرض تتحرر، لتشكّل قاعدة ارتكاز لتحرير باقي التراب الفلسطيني. كان واضحًا أن هذه الانعطافة جاءت في سياق محاولة النظام العربي الرسمي إقحام منظمة التحرير الفلسطينية في عملية التسوية السياسية التي بدأ الترويج لها عقب حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، وأن المقصود بالأراضي المحررة هو الضفة الغربية وقطاع غزة اللتان سيتم استعادتهما عبر عملية السلام المفترضة، وأن هذا الحل المرحلي شكّل خيارًا بديلًا من استراتيجية التحرير الكامل.
أدى هذا الخيار إلى تأجيج الصراع مع النظام الأردني، ولاحقًا مع النظام السوري، حول الجهة التي سيكون لها مقعد في قطار التسوية الذي لم يتحرك، والمخولة بالتفاوض على مصير الأرض المحتلة التي اعتُبرت، بعد قرار قمة الرباط عام 1974 الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، أرضًا متنازعًا عليها. كما تبيّن للقيادة الفلسطينية أن الانخراط في هذا المسار يختلف تمامًا عمّا قاله لهم الرئيس السادات حين خيّرهم بين استعادة الضفة الغربية أو تركها للملك حسين، وكأنّ العدو الصهيوني مستعد لتسليم مفاتيحها للجهة التي تحظى بالقبول العربي والدولي، وسرعان ما اكتشفوا أنّ هذا الأمر دونه خرط القتاد، وأنّ ثمة معارك عسكرية كبرى عليهم أن يخوضوها، وتنازلات جسيمة يجب تقديمها، وثمة تحالفات تتغيّر وتتبدل، وشروط ينبغي قبولها، وسياسات وقيادات يجب أن تتأهل لتتوافق مع السلام المنشود، فكان نبذ الإرهاب، وقبول قرار 242، والاعتراف بإسرائيل، واعتبار الميثاق الوطني غير فعال (كادوك)، قبل أن تُعدّل بنوده، والاتفاق مع الأردن على اتحاد كونفدرالي، وعلى الرغم من إلغائه لاحقًا، فقد تم الذهاب تحت مظلة أردنية إلى مؤتمر مدريد، ليتم لاحقًا الالتفاف على الوفد الفلسطيني المفاوض، والذي ترأسه الدكتور حيدر عبد الشافي من خلال نافذة أوسلو، بعد مخاوف قيادة المنظمة من وصول قناة مدريد إلى نتائج تهدد مكانتها التمثيلية.
تراجعت خيارات قيادة منظمة التحرير في اتفاق أوسلو، إذ وافقت على حكم ذاتي محدود، كما اعترفت بحق إسرائيل في الوجود، مقابل اعتراف إسرائيل بالمنظمة ممثلة للفلسطينيين في مفاوضات الحل النهائي التي أُحيلت إليها القضايا المهمة كلها، مثل الأرض والمستوطنات والقدس واللاجئين. وبعد فشل هذه المفاوضات في كامب ديفيد عام 2000، لجأت هذه القيادة إلى خيار آخر تمثّل بالانتفاضة المسلحة، على أمل أن تؤدي بعض العمليات العسكرية إلى تراجع العدو الصهيوني عن تشدده، وتحقق حلم الدولة في الضفة والقطاع، وفق معادلة الأرض مقابل السلام. خرج الوضع عن السيطرة، ولم يعد ممكنًا ضبط وتيرة العمليات الاستشهادية وفق مناورات القيادة السياسية، وحوصر ياسر عرفات في مقره في رام الله، وقُتل مسمومًا، لتبدأ مرحلة جديدة وخيارات أخرى.
كان خيار السلطة الفلسطينية في عهد محمود عباس مختلفًا، فقد أعاد إنتاج أوسلو على أسس جديدة، فزاد من وتيرة التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني الذي أصبح مقدسًا، وأعاد تأهيل قوات الأمن الفلسطينية بإشراف الجنرال الأميركي كيث دايتون، واعتبر الانتفاضة كارثة، وصواريخ المقاومة عبثية. وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن من تحقيق أي تقدّم في المفاوضات التي سرعان ما توقفت تمامًا، واستباحت القوات الإسرائيلية كافة أنحاء الضفة الغربية، بما فيها مناطق السلطة الفلسطينية، وازدادت وتيرة الاستيطان. كان خيار السلطة الحقيقي هو محاولة إقناع الطرف الإسرائيلي، عبر الرضوخ لجميع شروطه، باستئناف المفاوضات من حيث توقفت.
لم يطل الوقت حتى جاء مشروع ترامب - نتنياهو المعروف بصفقة القرن، وما إن اتضحت معالمه حتى لم يعد من خيار أمام السلطة الفلسطينية غير معارضته، ذلك أنه ينهي تمامًا دور السلطة الفلسطينية. ولذا، فقد وقفت الساحة الفلسطينية، بعد انتظار، موقفًا موحدًا شاركت فيه الفصائل كلها، وأُعلن عن تعليق كافة الاتفاقات الموقعة مع العدو، ووقف التنسيق الأمني، وتفعيل المقاومة الشعبية، وصدرت مراسم رئاسية لإجراء انتخابات متتابعة للمجلس التشريعي والرئاسة، واستكمال أعضاء المجلس الوطني.
بعد هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية الأخيرة، تراجع الضم القانوني للأراضي والمستوطنات في الضفة الغربية، لكن الضم الفعلي، والسيطرة الإسرائيلية على أكثر من 70 في المائة من أراضي الضفة، بقي على حاله، بينما تغيّرت خيارات السلطة، وعادت الأمور إلى ما كانت عليه، فلم تعد السلطة بحاجة إلى إنهاء الانقسام، أو تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية. عادت من جديد إلى خياراتها السابقة، لكن المشكلة التي واجهتها أن الطرف الصهيوني لم يعد معنيًا حتى بالحديث عن حل الدولتين، ولا بالمفاوضات، حتى وإن كانت شكلية، والمجتمع الدولي حريص على إبقاء السلطة الفلسطينية على قيد الحياة، لكن في غرفة الإنعاش كي يستمر وجودها بحده الأدنى، وسط ازدياد واضح للتأثير الإسرائيلي في قراراتها. فخيارها الحالي يتمثّل في بقاء السلطة عبر محاولات تحسين الوضع الاقتصادي عبر أموال المقاصة والمساعدات الأجنبية، والتعايش مع الاحتلال. ومع انسداد الأفق السياسي، وتراجع حل الدولتين، كان لا بد لهذا لخيار من أن يلوح ببدائل للإبقاء على الحد الأدنى من شرعيته، وهو يعلم استحالة قبولها وتحقيقها، مثل التهديد بعد عام بالعودة إلى قرار التقسيم الذي يمنح الفلسطينيين 45 في المائة من فلسطين، بدلًا من 22 في المائة في حل الدولتين، أو التلويح بالدولة الواحدة، وما تحمله من تهديد ديمغرافي لبقاء الدولة اليهودية، دون وجود أي برنامج نضالي خلف هذه الخيارات. ما يعني أن خيارها الفعلي لا يتعدى الانتظار والمرواحة في ذات المكان، في الوقت الذي يتقدم فيه المشروع الصهيوني على الأرض الفلسطينية، وفي اتجاه التطبيع الرسمي العربي، أما السلطة الفلسطينية فتقف عاجزة عن تبني خيار المقاومة، وملاحقة العدو في المحافل الدولية، وإنهاء الانقسام، ووقف التنسيق الأمني. وغني عن الذكر أن هذا الخيار يضع قرار إنهاء السلطة والتحكم فيها بيد الاحتلال متى واتته اللحظة الملائمة، أو تجزئتها ضمن معازل وكانتونات، أو أن يستبدل بها نمطًا أكثر مواءمة له ولمصالحه.
ثمة من يدعو إلى خيار آخر قوامه حل السلطة الفلسطينية، ويمكن التمييز بين مجموعتين تدعوان إلى هذا الحل؛ الأولى أطلقتها قيادات في السلطة ذاتها، وفي مقدمتهم الرئيس محمود عباس الذي هدد أكثر من مرة بحل السلطة، وتسليم مفاتيح مكتبه للحكومة الإسرائيلية، وهي تهديدات لفظية، الهدف منها تذكير الإسرائيليين بالدور الذي تؤديه السلطة في التقليل من كلفة الاحتلال. أما المجموعة الثانية فتشمل بعضاً من معارضي السلطة الفلسطينية، وهؤلاء يغيب عنهم أن السلطة لن تقوم بحل ذاتها، وأن الاحتلال قادر على تنصيب أحد رجال الأمن رئيساً لسلطة يخترعها هو.
تغيير وظيفة السلطة الفلسطينية لتصبح وظيفة خدمية خيار آخر، وهو يعني وقف المهمات الأمنية والتنسيق الأمني مع العدو، والاكتفاء بتأدية المهمات الشرطية والخدمية، مثل التعليم والصحة، ومهمات البلديات، وترك المهمات السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد إعادة بنائها، والتي بدورها ستصبح الجهة السياسية المرجعية التي تقود النضال الفلسطيني كله، سواء كان ذلك في الضفة وغزة فينتهي بذلك الانقسام، أم في الشتات وفلسطين المحتلة منذ عام 1948. يحتاج هذا الخيار إلى نضال جماهيري واسع، ويرتبط بشكل عضوي مع تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، وضد ارتهان السلطة له. وفي حال تعيين سلطات الاحتلال ضباط أمن أو أشخاص يرتبطون معها، فإن البديل يكمن في البلديات المنتخبة، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني التي عليها أن تكون قادرة، في ظل الاحتلال، على حفظ مؤسسات المجتمع الفلسطيني وتطويرها، وهو الدور ذاته الذي قامت به قبل اتفاق أوسلو. وبذلك، يتمحور نضال الشعب الفلسطيني كله حول التحرر من الاستعمار الاستيطاني الكولنيالي الإحلالي في فلسطين التاريخية، وتصبح الحلقة المركزية لنضاله هي النضال ضد نظام الأبارتايد الصهيوني الذي يمارَس على الفلسطينيين كلهم في فلسطين والشتات.